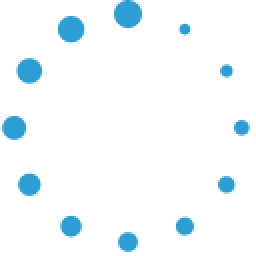|
ملحوظات عن القصيدة:
بريدك الإلكتروني - غير إلزامي - حتى نتمكن من الرد عليك
ادخل الكود التالي:

انتظر إرسال البلاغ...
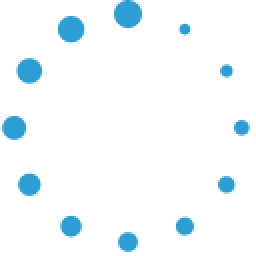
|

| نيويورك نوفمبر الشارعُ الخامسُ |
| الشمسُ صَحْنٌ من المعدن المتطاير |
| قُلْتُ لنفسي الغريبة في الظل: |
| هل هذه بابل أم سدوم؟ |
| هناك على باب هاوية كهربائيَّةٍ |
| بعُلوِّ السماء التقيتُ بإدوارد |
| قبل ثلاثين عاماً |
| وكان الزمان أَقَلَّ جموحاً من الآن |
| قال كلانا: |
| إذا كان ماضيك تجربةً |
| فاجعلِ الغَدَ معنى ورؤيا! |
| لنذهبْ |
| لنذهبْ إلى غدنا واثقين |
| بصدق الخيال ومعجزة العشبِ |
| لا أَتذكَّر أنَّا ذهبنا إلى السينما |
| في المساء . ولكنْ سمعْتُ هنوداً |
| قدامى ينادونني: |
| لا تَثِقْ بالحصان ولا بالحداثِة |
| لا لا ضحيَّةَ تسأل جلاّدها: |
| هل أَنا أَنت؟ لو كان سيفيَ |
| أكبرَ من وردتي هل ستسأل |
| إن كُنْتُ أَفعل مثلَكْ؟ |
| سؤالٌ كهذا يثير فُضُولَ الروائيِّ |
| في مكتبٍ من زجاج يُطلُّ على |
| زنبق في الحديقة ... حيث تكونُ |
| يَدُ الفرصيّة بيضاءَ مثل ضمير |
| الروائيّ حين يُصَفِّي الحساب |
| مع النزعة البشرية: لا غَدَ |
| في الأمس فلنتقدَّمْ إذاً! |
| قد يكون التقدُّمُ جسرَ الرجوع |
| إلى البربريَّة... |
| نيويورك . إدوار يصحو على كسل |
| الفجر. يعزف لحناً لموتسارت . يركض |
| في ملعب التنس الجامعيّ. يفكّر في |
| هجرة الطير عبر الحدود وفوق الحواجز. |
| يقرأ نيويورك تايمز يكتب تعليقَهُ |
| المتوتّر . يلعن مستشرقاً يرشد الجنرال |
| إلى نقطة الضعف في قلب شرقيّة. |
| يستحمُّ. ويختار بدلَتهُ بأناقة دِيكٍ. |
| ويشرب قهوته بالحليب . ويصرخ |
| بالفجر: هيّا ولا تتلكَّأ |
| على الريح يمشى . وفي الريح |
| يعرف مَنْ هُوَ. لا سقف للريح. |
| لا بيت للريح بُوصلةٌ |
| لشمال الغريب. |
| يقول: أَنا من هناك . أَنا من هنا |
| ولستُ هناك ولستُ هنا |
| لِيِ اسمانِ يلتقيان ويفترقان |
| ولي لُغتان نسيت بأيَّهما |
| كنتُ أَحلُمُ |
| لي لُغَةٌ إنجليزيَّةٌ للكتابة |
| طيِّعةُ المفردات |
| ولي لغةٌ من حوار السماء مع |
| القدس فضيَّةُ النَّبْرِ لكنها |
| لا تُطيعُ مخيّلتي! |
| والهويَّةُ؟ قلتُ |
| فقال: دفاعٌ عن الذات ... |
| إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة لكنها |
| في النهاية إبداعُ صاحبها لا |
| وراثة ماضٍ. أَنا المتعدِّد. في |
| داخلي خارجي المتجدِّدُ... لكنني |
| أَنتمي لسؤال الضحيَّة . لو لم |
| أكن من هناك لدرَّبْتُ قلبي |
| على أن يُربِّي هناك غزال الِكنايَةِ. |
| فاحملْ بلادك أَنَّى ذَهَبْتَ... |
| وكُنْ نرجسيّاً إذا لزم الأَمرُ |
| منفىً هو العالم الخارجيُّ |
| ومنفىً هو العالم الداخليُّ |
| من أَنت بينهما؟ |
| لا أُعرِّفُ نفسي تماماً |
| لئلاّ أُضيِّعها. و أَنا ما أَنا |
| وأنا آخري في ثُنَائيّةٍ |
| تتناغم بين الكلام وبين الإشارةْ. |
| ولو كنت أكتب شعراً لقلت: |
| أنا اثنان في واحد |
| كجناحَيْ سُنُونُوّةٍ |
| إن تأخَّر فَصْلُ الربيع |
| اكتفيتُ بحمل البشارةْ |
| يحبُّ بلاداً ويرحل عنها |
| هل المستحيل بعيد؟ |
| يحبُّ الرحيل إلى أيِّ شيء |
| ففي السفر الحر بين الثقافات |
| قد يجد الباحثون عن الجوهر البشريّ |
| مقاعدَ كافيةً للجميع . |
| هنا هامش يتقدَّم. أو مركز يتراجع |
| لا الشرقُ شرقٌُ تماماً |
| ولا الغربُ غربٌ تماماً |
| لأن الهويَّةَ مفتوحةٌ للتعدُّد |
| لا قلعةً أو خنادقَ |
| كان المجازُ ينام على ضفّة النهر |
| لولا التَلَوُّثُ |
| لا حْتَضَنَ الضفَّةَ الثانيةْ |
| هل كتبتَ الروايةَ؟ |
| حاولتُ....حاولت أن أستعيد بها |
| صورتي في مرايا النساء البعيدات |
| لكنهن توغَّلْنَ في ليلهنَّ الحصين |
| وقلن: لنا عالم مستقلٌّ عن النصّ |
| لن يكتب الرجلُ المرأةَ اللغزَ والحُلْمَ |
| لن تكتب المرأةَ الرجل الرمز والنجمَ |
| لا حُبَّ يشبه حباً |
| ولا ليل يشبه ليلاً |
| دعونا نُعدِّدْ صفات الرجال ونضحكْ! |
| وماذا فعلتَ؟ |
| ضحكت على عبثي |
| ورميتُ الروايةَ في سلة المهملات! |
| المُفَكَّرُ يكبَحُ سَرْدَ الروائيّ |
| والفيلسوف يُشَرِّحُ وَرْدَ المُغَنّي |
| يحبُّ بلاداً ويرحل عنها: |
| أنا ما أكون وما سأكون |
| سأصنع نفسي بنفسي |
| وأختار منفايَ |
| منفايَ خلفيّةُ المشهد الملحميّ |
| أُدافع عن حاجة الشعراء |
| إلى الغد والذكريات معاً |
| وأدافع عن شَجَرٍ ترتديه الطيورُ |
| بلاداً ومنفى |
| وعن قمر لم يزل صالحاً لقصيدة حُبّ |
| أُدافع عن فكرة كسرتها هشاشةُ أصحابها |
| وأدافع عن بلد خَطَفَتْهُ الأساطيرُ |
| هل تسطيع الرجوعَ إلى أي شيء؟ |
| أمامي يجرُّ ورائي ويُسرع... |
| لا وقت في ساعتي لأخُطَّ سطوراً |
| على الرمل. لكنني أستطيع زيارة أمس |
| كما استمعوا في المساء |
| إلى الشاعر الرَّعَوِيِّ: |
| فتاةٌ على النبع تملأ جَرَّتها |
| بحليب السحابْ |
| وتبكي وتضحك من نَحْلَةٍ |
| لسعت قلبها في مهبِّ الغيابْ |
| هل الحُبُّ ما يوجع الماءَ |
| أَم مَرَضٌ في الضبابْ..؟ |
| إلى آخر الأُغنية |
| إذن قد يصيبك داءُ الحنين؟ |
| حنينٌ إلى الغد ... أبعد أَعلى |
| وأَبعد. حُلْمي يقود خُطاي . ورؤيايَ |
| تُجلْسُ حُلْمي على ركبتيّ كقطِّ أَليف. |
| هو الواقعيُّ الخياليُّ وابن الإدارة: |
| في وسعنا |
| أَن نُغيِّر |
| حتميَّة الهاويةْ! |
| والحنينُ إلى أمس؟ |
| عاطفةٌ لا تَخُصُّ المفكِّر إلاَّ |
| ليفهم تَوْقَ الغريب إلى أدوات الغياب |
| وأَمَّا أنا فحنيني صراعٌ على حاضرٍ |
| يُمْسِكُ الغَدَ من خِصْيَتيه |
| ألم تتسلّلْ إلى أمس حين ذهبتَ |
| إلى البيت بيتك في حارة الطالبيّة؟ |
| هَيَّأتُ نفسي لأن أَتمدَّد في |
| تخت أُمي كما يفعل الطفل حين يخاف |
| أَباه. وحاولت أن أستعيد ولادة |
| نفسي وأَن أَتتبَّع درب الحليب |
| على سطح بيتي القديم، وحاولتُ أن |
| أتحسِّس جلدَ الغياب ورائحةَ الصيف |
| من ياسمين الحديقة . لكن وحش الحقيقة |
| أَبعدني عن حنين تلفَّتَ كاللص خلفي |
| وهل خفت؟ ماذا أخافك؟ |
| لا أستطيع لقاء الخسارة وجهاً |
| لوجه . وقفت على الباب كالمتسوّل. |
| هل أطلب الإذن من غرباء ينامون فوق |
| سريري أنا ... بزيارة نفسي لخمس دقائق؟ |
| هل أَنحني باحترام لُكان حلمي الطفوليِّ؟ |
| هل يسألون: مَنِ الزائرُ الأجنبيُّ |
| الفضوليُّ؟ هل أستطيع الكلام عن |
| السلم والحرب بين الضحايا وبين ضحايا |
| الضحايا بلا جملة اعتراضيّةٍ؟ هل |
| يقولون لي: لا مكان لحلمين في |
| مَخْدَع واحدٍ؟ |
| لا أَنا أَو هُوَ |
| ولكنه قارئ يتساءل عمَّا |
| يقول لنا الشعرُ في زمن الكارثةْ |
| دمٌ |
| ودمٌ، |
| ودمٌ |
| في بلادك |
| في اسمي وفي اسمك في زهرة |
| اللوز في قشرة الموز في لبن |
| الطفل، في الضوء والظلّ في |
| حبة القمح، في عُلبة الملح |
| قَنَّاصَةٌ بارعون يصيبون أَهدافهم |
| باميتاز |
| دماً |
| ودماً |
| ودماً... |
| هذه الأرض أَصغرُ من دم أبنائها |
| الواقفين على عتبات القيامة مثل |
| القرابين. هل هذه الأرض حقاً |
| مباركةٌ أَم مُعَمَّدَّةٌ |
| بدمٍ، |
| ودمٍ، |
| ودمٍ |
| لا تُجفِّفُه الصلوات ولا الرمل. |
| لا عَدْلَ في صفحات الكتاب المُقَدَّس |
| يكفي لكي يفرح الشهداءُ بحريّة |
| المشي فوق الغمام. دم في النهار. |
| دم في الظلام . دم في الكلام. |
| يقول: القصيدةُ قد تستضيفُ الخسارة |
| خيطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة. |
| أومسيحاً على فرس مثخناً بالمجاز |
| الجميل . فليس الجماليّ إلاّ حضورَ |
| الحقيقيِّ في الشكل |
| في عالم لا سماء له تصبح الأرضُ |
| هاويةً . والقصيدة إحدى هبات العزاء |
| وإحدى صفات الرياح شماليةً أو جنوبيةً. |
| لا تَصِفْ ماترى الكاميرا من جروحك. |
| واصرخ لتسمع نفسك واصرخ لتعلم |
| أنك ما زلتَ حيّاً وحيّاً وأن الحياة |
| على هذه الأرض ممكنةٌ. فاخترع أملاً |
| للكلام ابتكرْ أو سراباً |
| يطيل الرجاء |
| وغنِّ فإنَّ الجماليَّ حريَّةٌ |
| أقول:سنحيا ولو تركتنا الحياةُ |
| إلى شأننا . فلنكن سادة الكلمات |
| التي سوف تجعل قُرَّاءها خالدين |
| على حدّ تعبير صاحبك الفذِّ ريتسوس |
| وقال: إذا متُّ قبلك |
| أُوصيكَ بالمستحيلْ! |
| سألت: هل المستحيل بعيد؟ |
| فقال: وإن متّ قبلك؟ |
| قال: أُعزِّي جبال الجليلْ |
| واكتب:ليس الجماليُّ إلاّ بلوغَ |
| الملائم. والآن لا تنس: |
| إن متُّ قبلك أوصيك بالمستحيلْ |
| عندما زرتُهُ في سَدُومَ الجديدةِ |
| في عام ألفين واثنين كان |
| يقاوم حَرْبَ سَدُومَ على أهل بابل |
| والسرطان معاً |
| كان كالبطل الملحميِّ الأخير |
| يدافع عن حَقّ طروادةٍ |
| في اقتسام الرواية |
| نسرٌ يودِّع قمَّتَهُ عالياً |
| عالياً |
| فإقامة فوق الأولمب |
| وفوق القِمَمْ |
| قد تثير السَّأمْ |
| وداعاً |
| وداعاً لشعر الأَلمْ! |